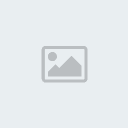الكون في لوحة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
 الكون في لوحة
الكون في لوحة
لست ممن التقوا بالسيدة أسماء فيومي او عرفوها معرفة شخصية ، او حتى قرأوا عنها من قبل، لكني عرفتها من حديث زوجها ، الصديق المخرج الكبير غسان جبري . لقد دعاني بكثير من الحماس، لكي احضر معرضها الأخير ، الذي أقيم في غاليري "أيام " في دمشق ، بعد أن أهداني الكتاب الذي صدر عنها بمناسبة المعرض . وهكذا بقيت يوما آخر في هذه المدينة التي كانت تتحضر للعاصفة الثلجية الثانية .
في الليلة السابقة للمعرض ، أتيح لي أن افتح هذا الكتاب الأنيق الذي ازدان ببعض من أعمالها المعروضة ، و كذلك المقالات التي كتبها نقاد معروفون. و ما حدث مع زوجها حينما وقع نظره لأول مرة على أعمالها ، حدث معي تماما . الفرق أنني كنت اعرف على الأقل من هي ، وأتوق للقائها في اليوم التالي، بينما قضى هو ليلته مستفزا يفكر " ترى من رسم هذه العيون الكبيرة التي يحيط بها لون الدم " .
لقد كان كلاهما " صانعين للحياة " ، هو من خلال إعادة تركيب الواقع بعدسة الكاميرا والعين المختبئة خلفها بحنكة، و هي من خلال ألوانها والقماش وكم كبير من الوجدان الأنثوي الذي لا يمكن حصره ، وقد اخذ يتراكم شيئا فشيئا .
اية لحظة مسحورة سمحت للقاء غسان و أسماء أن يتم ؟! أية غفلة ربانية تركت هذا اللقاء أن يصل لأوجه ، لا بارتباطهم المقدس وحسب ، و إنما بما منحا هذه الدنيا ،كجزء من ابداعهما الشخصي و القدري، أقصد بذلك الرجال الأربعة ، أولادهم الذين يتألقون اليوم ،كل منهم في موقعه، تماما كوالديهما .
لست من المولعين حقا بدراسة الفن التشكيلي انطلاقا من هذه التعابير الصعبة و المملة التي يستعملها المحترفون ، فانا كتبت عن أهم فناني العرب بلغة أخرى هي اقرب لي ولهم وللقارىء ، مقتنعة ان مثل هذه " الاصطلاحات الفنية الفسيفسائية الأكاديمية " ، لن توصل للمتلقي رسالتي وما اريد قوله عن الفنان، بل انني لست معنية كثيرا بتقنيته و تطورها... أقول هذا صراحة . ان ما يهمني و ما يشغل بالي هو الصدق و الحوار في هذه التقنية ، و ذلك التطور المتبدي في اللوحة ، مهما كانت هذه اللوحة . إنني في الحقيقة ابحث عن الفنان في الخط، في اللون، في الضوء، في خامة القماش، و لا ابحث عنه في أي أمر آخر . ابحث عن " الروح " الكامنة في حركة المشهد و رمزيته تماما كما قررت ذات يوم أسماء الفيومي ، أن " ترسم روح الأشياء ". و ذلك عندما رأت الآخرين كيف يرسمون دمشق . حينذاك قررت أن ترسم عطر الوردة لا الوردة ، ان تحور الشيء و تبدل فيه ، ان تحطمه و ان تعيد بناءه بقدر ما يسمح ذلك للروح " بالطلوع " على سطح القماشة . ان هذا تماما ما يلفت انتباهي في اللوحة . روح الكون المحبوسة فيها ، روح الفنان و روح الآخرين و روح تفاصيل الحياة المارقة حقا .
حين دخلت إلى معرض " السيدة " كانت رائحة البخور تملأ المكان . لقد كان الغاليري يشي ببحبوحة الرفاهية . كل شيء معد لكي تستقبل الحواس اللوحة ؛ الضوء المنتشر بحياء هنا و هناك ، الرائحة التي عطرت المكان ، و الموسيقى التي يعجز عقلي الآن على استذكارها و إنما بقي منها نوتات قليلة جميلة لا يمكن ان تنسى ، لقد بقي منها انطباع يشبه ذلك الذي تتركه كلمات الحب الأولى في اللقاء الأول حيث جمال اللحظة يجعل منها " أمراً لا يصدق و غير قابل للاستعادة " .
كانت السيدة أسماء، و إلى جانبها زوجها المخرج العريق بربطة عنقه الاحتفالية ، تقف مكتوفة اليدين ، تستمع إلى تعليقات إحدى الكاتبات ، بينما تحلق آخرون حولهما . لقد كان التعليق مجاملا و باهتا و ربما وجدته لا يليق بهذه الأفكار المقدسة التي كانت تفور من الجداريات . ابتعدت قليلا و بدأت رحلتي ، لوحة لوحة ، لا في أدغالِ آخر ما توصلت إليه ريشة الفنانة و هي تجرب عبر ثلاثة أو أربعة عقود من الزمن كيف ترسم الروح، و إنما في هذه الوجوه الامومية النسائية التي اختزلت إلى درجة كبيرة " تطور الأنثى " .
لقد رأيت قناة أسماء فيومي التي تصلها بكل النساء في اللوحات بأم عيني . رأيت فضاء الشاهدة على عصرها و المشاركة في الجرم في آن ، فضاء وحشة الحرملك المرة و الاستلقاء الحر تحت شمسه ، فضاء السيدة في ثياب الخادمة و العكس ، فضاء الشغف الحرام و أصولية المشاعر المدروسة ، فضاء البحث عن الأنوثة في جوارير المكاتب و قوانين العمل الذكورية الصارمة ، و التوق للاختباء في عباءة " سي السيد " ، فضاء اللهث وراء الجوائز التقديرية و الرغبة في الانزواء في مطبخ العائلة الممل ، فضاء الخوف من الرجل و تخويفه ، فضاء المساواة و التمييز ، و كذلك فضاء إعاقة الدونية المحبطة و الخشية من التفوق .. و اخيرا فضاء محاربة العنف المشروع و السعي الخفي وراءه .
لقد سمعت ثرثرة صاخبة في هذه اللوحات .. ثرثرة نساء كثيرات فاقدات أو متقدات الذاكرة ، ثرثرة لا تختزل بواحدة في حمية الدفاع عنها ضد كل أشكال التمييز و العنف ، و انما يلم اللون و المشهد في داخلهما المرأة الطفل ، و المراهقة الأبدية ، و المرأة المنافسة ، و المرأة العقلانية ، و المرأة النرجسية ، و المازوخية ، و تلك التي تسعى في كل حركة للحصول على الأمن ، وتلك التي تمارس الختان الروحي على نفسها ، وتلك التي ختنت تحت مشرط " التهذيب البشع " . ان حديث اللوحات موجه حقا لامرأة كل يوم ، لامرأة بلادي و بلاد العالم .
انه حديث عن المرأة التي " تريد ان تضفي صفة شخصية على كل شيء ، العاجزة عن تطبيق عدالة ما ، من دون ان تعرف الوجه الإنساني لمن هو موضوع الاتهام ، لأنها ترفض اللاشخصية في الكلمات و الأفكار " .[1]
انه حديث عنها ، تلك الطالعة من الذاكرة الشعبية ، وتلك التي مجدتها الدراما السينمائية . امرأة لم " يعمرها " رجل مفتون بها ، و إنما آخر ، أراد قطع رقبتها باسم الحب و ادعاء الحفاظ عليها .
كون أسماء الفيومي رحب ، ربما أوسع من أية جدارية ، أوسع من أية دراما يمكن أن تخطها كاميرا أو يفكر فيها سيناريست يقمع إبداعه قمعا بدواعي اعتبارات السوق ، بينما تطلق هي لحريتها العنان في كل " ضربة ريشة " .
لوحات أسماء فيومي تشي بحرية من دون حواف ، بتاريخ شخصي طويل بدأ منذ تفتح المؤسسة الوطنية في سوريا عام 1943 و حتى هذا اليوم الذي تتوق فيه الفنانة و زوجها ، إلى المجتمع الشامي العريق الذي يتألق بنخبه الفكرية و بعلمانيته التي تحترم الأديان و تجلها ، و بتطلعه إلى حداثة مرتبطة بأجمل و أذكى ما في تقاليدنا و عاداتنا . انه مجتمع البحبوحة الذي يعيش فيه الفن حقا و لا يخبو على قرقعة خواء البطون و العقول ، التي أثقلت كاهلها ثقافة تلقينية لا تقدم أو تؤخر .
إني اشترك معها و مع زوجها المخرج الذي يختزل تاريخ الدراما السورية في روحه و عينه التي طالما تطلعت إلى حياتنا من بؤرة العدسة ، اشترك معهما في هذا الحلم و أتوق لذاك اليوم الذي لا تتحكم فينا طلعات و نزلات الاقتصاد ، و لا نوبات الرومانسية الطارئة أمام مدن الباطون المسلح ، و لا الثقافات الأخرى السائدة التي لا تمت لروحنا العريقة بصلة .
اليوم تستمع أسماء إلى موسيقى ابنها الفنان زيدون و هي ترسم بدلا من أساطين الكلاسيكية مثل شوبان و آخرين . انها فخورة باستعادة " عز الشام " من خلال عبقرية ابنها ، القها و روحها التي طمستها ثقافة " المرحلة " . اما غسان جبري فانه يتوق إلى دراما على صورته و مثاله بعد " تجريب " طويل عريض على الحارات الشامية و أزقتها و حكاياها . انه متيم إلى أقصى حد كزوجته، ممتلىء مثلها شغفا و إبداعا كبحر ، مدركا أن الاحباطات السياسية و الاجتماعية الماضية هي توكيد لرؤيته الفذة ، لحال هذه الدنيا حولنا .
عندما التقيت بهما ، كانا طافحين على آخرهما بالروح ، مترعين ككأس ، بتجارب الماضي .
و بدلا من أن المح خطوطاً حزينة على وجهيهما شأن كل سكان الشرق الأوسط الأكثر إبداعا و إنتاجا ، كانت ابتسامة بريئة عامرة مثل ابتسامة طفل تشرق في وجهيهما . انها ابتسامة الممتن لكرم الله الذي منَ عليهما بنعمة الفن المباركة التي حمتهما و صانتهما من جنون فالت من عقاله يسمى : الدنيا .
بقلم : كلاديس مطر
في الليلة السابقة للمعرض ، أتيح لي أن افتح هذا الكتاب الأنيق الذي ازدان ببعض من أعمالها المعروضة ، و كذلك المقالات التي كتبها نقاد معروفون. و ما حدث مع زوجها حينما وقع نظره لأول مرة على أعمالها ، حدث معي تماما . الفرق أنني كنت اعرف على الأقل من هي ، وأتوق للقائها في اليوم التالي، بينما قضى هو ليلته مستفزا يفكر " ترى من رسم هذه العيون الكبيرة التي يحيط بها لون الدم " .
لقد كان كلاهما " صانعين للحياة " ، هو من خلال إعادة تركيب الواقع بعدسة الكاميرا والعين المختبئة خلفها بحنكة، و هي من خلال ألوانها والقماش وكم كبير من الوجدان الأنثوي الذي لا يمكن حصره ، وقد اخذ يتراكم شيئا فشيئا .
اية لحظة مسحورة سمحت للقاء غسان و أسماء أن يتم ؟! أية غفلة ربانية تركت هذا اللقاء أن يصل لأوجه ، لا بارتباطهم المقدس وحسب ، و إنما بما منحا هذه الدنيا ،كجزء من ابداعهما الشخصي و القدري، أقصد بذلك الرجال الأربعة ، أولادهم الذين يتألقون اليوم ،كل منهم في موقعه، تماما كوالديهما .
لست من المولعين حقا بدراسة الفن التشكيلي انطلاقا من هذه التعابير الصعبة و المملة التي يستعملها المحترفون ، فانا كتبت عن أهم فناني العرب بلغة أخرى هي اقرب لي ولهم وللقارىء ، مقتنعة ان مثل هذه " الاصطلاحات الفنية الفسيفسائية الأكاديمية " ، لن توصل للمتلقي رسالتي وما اريد قوله عن الفنان، بل انني لست معنية كثيرا بتقنيته و تطورها... أقول هذا صراحة . ان ما يهمني و ما يشغل بالي هو الصدق و الحوار في هذه التقنية ، و ذلك التطور المتبدي في اللوحة ، مهما كانت هذه اللوحة . إنني في الحقيقة ابحث عن الفنان في الخط، في اللون، في الضوء، في خامة القماش، و لا ابحث عنه في أي أمر آخر . ابحث عن " الروح " الكامنة في حركة المشهد و رمزيته تماما كما قررت ذات يوم أسماء الفيومي ، أن " ترسم روح الأشياء ". و ذلك عندما رأت الآخرين كيف يرسمون دمشق . حينذاك قررت أن ترسم عطر الوردة لا الوردة ، ان تحور الشيء و تبدل فيه ، ان تحطمه و ان تعيد بناءه بقدر ما يسمح ذلك للروح " بالطلوع " على سطح القماشة . ان هذا تماما ما يلفت انتباهي في اللوحة . روح الكون المحبوسة فيها ، روح الفنان و روح الآخرين و روح تفاصيل الحياة المارقة حقا .
حين دخلت إلى معرض " السيدة " كانت رائحة البخور تملأ المكان . لقد كان الغاليري يشي ببحبوحة الرفاهية . كل شيء معد لكي تستقبل الحواس اللوحة ؛ الضوء المنتشر بحياء هنا و هناك ، الرائحة التي عطرت المكان ، و الموسيقى التي يعجز عقلي الآن على استذكارها و إنما بقي منها نوتات قليلة جميلة لا يمكن ان تنسى ، لقد بقي منها انطباع يشبه ذلك الذي تتركه كلمات الحب الأولى في اللقاء الأول حيث جمال اللحظة يجعل منها " أمراً لا يصدق و غير قابل للاستعادة " .
كانت السيدة أسماء، و إلى جانبها زوجها المخرج العريق بربطة عنقه الاحتفالية ، تقف مكتوفة اليدين ، تستمع إلى تعليقات إحدى الكاتبات ، بينما تحلق آخرون حولهما . لقد كان التعليق مجاملا و باهتا و ربما وجدته لا يليق بهذه الأفكار المقدسة التي كانت تفور من الجداريات . ابتعدت قليلا و بدأت رحلتي ، لوحة لوحة ، لا في أدغالِ آخر ما توصلت إليه ريشة الفنانة و هي تجرب عبر ثلاثة أو أربعة عقود من الزمن كيف ترسم الروح، و إنما في هذه الوجوه الامومية النسائية التي اختزلت إلى درجة كبيرة " تطور الأنثى " .
لقد رأيت قناة أسماء فيومي التي تصلها بكل النساء في اللوحات بأم عيني . رأيت فضاء الشاهدة على عصرها و المشاركة في الجرم في آن ، فضاء وحشة الحرملك المرة و الاستلقاء الحر تحت شمسه ، فضاء السيدة في ثياب الخادمة و العكس ، فضاء الشغف الحرام و أصولية المشاعر المدروسة ، فضاء البحث عن الأنوثة في جوارير المكاتب و قوانين العمل الذكورية الصارمة ، و التوق للاختباء في عباءة " سي السيد " ، فضاء اللهث وراء الجوائز التقديرية و الرغبة في الانزواء في مطبخ العائلة الممل ، فضاء الخوف من الرجل و تخويفه ، فضاء المساواة و التمييز ، و كذلك فضاء إعاقة الدونية المحبطة و الخشية من التفوق .. و اخيرا فضاء محاربة العنف المشروع و السعي الخفي وراءه .
لقد سمعت ثرثرة صاخبة في هذه اللوحات .. ثرثرة نساء كثيرات فاقدات أو متقدات الذاكرة ، ثرثرة لا تختزل بواحدة في حمية الدفاع عنها ضد كل أشكال التمييز و العنف ، و انما يلم اللون و المشهد في داخلهما المرأة الطفل ، و المراهقة الأبدية ، و المرأة المنافسة ، و المرأة العقلانية ، و المرأة النرجسية ، و المازوخية ، و تلك التي تسعى في كل حركة للحصول على الأمن ، وتلك التي تمارس الختان الروحي على نفسها ، وتلك التي ختنت تحت مشرط " التهذيب البشع " . ان حديث اللوحات موجه حقا لامرأة كل يوم ، لامرأة بلادي و بلاد العالم .
انه حديث عن المرأة التي " تريد ان تضفي صفة شخصية على كل شيء ، العاجزة عن تطبيق عدالة ما ، من دون ان تعرف الوجه الإنساني لمن هو موضوع الاتهام ، لأنها ترفض اللاشخصية في الكلمات و الأفكار " .[1]
انه حديث عنها ، تلك الطالعة من الذاكرة الشعبية ، وتلك التي مجدتها الدراما السينمائية . امرأة لم " يعمرها " رجل مفتون بها ، و إنما آخر ، أراد قطع رقبتها باسم الحب و ادعاء الحفاظ عليها .
كون أسماء الفيومي رحب ، ربما أوسع من أية جدارية ، أوسع من أية دراما يمكن أن تخطها كاميرا أو يفكر فيها سيناريست يقمع إبداعه قمعا بدواعي اعتبارات السوق ، بينما تطلق هي لحريتها العنان في كل " ضربة ريشة " .
لوحات أسماء فيومي تشي بحرية من دون حواف ، بتاريخ شخصي طويل بدأ منذ تفتح المؤسسة الوطنية في سوريا عام 1943 و حتى هذا اليوم الذي تتوق فيه الفنانة و زوجها ، إلى المجتمع الشامي العريق الذي يتألق بنخبه الفكرية و بعلمانيته التي تحترم الأديان و تجلها ، و بتطلعه إلى حداثة مرتبطة بأجمل و أذكى ما في تقاليدنا و عاداتنا . انه مجتمع البحبوحة الذي يعيش فيه الفن حقا و لا يخبو على قرقعة خواء البطون و العقول ، التي أثقلت كاهلها ثقافة تلقينية لا تقدم أو تؤخر .
إني اشترك معها و مع زوجها المخرج الذي يختزل تاريخ الدراما السورية في روحه و عينه التي طالما تطلعت إلى حياتنا من بؤرة العدسة ، اشترك معهما في هذا الحلم و أتوق لذاك اليوم الذي لا تتحكم فينا طلعات و نزلات الاقتصاد ، و لا نوبات الرومانسية الطارئة أمام مدن الباطون المسلح ، و لا الثقافات الأخرى السائدة التي لا تمت لروحنا العريقة بصلة .
اليوم تستمع أسماء إلى موسيقى ابنها الفنان زيدون و هي ترسم بدلا من أساطين الكلاسيكية مثل شوبان و آخرين . انها فخورة باستعادة " عز الشام " من خلال عبقرية ابنها ، القها و روحها التي طمستها ثقافة " المرحلة " . اما غسان جبري فانه يتوق إلى دراما على صورته و مثاله بعد " تجريب " طويل عريض على الحارات الشامية و أزقتها و حكاياها . انه متيم إلى أقصى حد كزوجته، ممتلىء مثلها شغفا و إبداعا كبحر ، مدركا أن الاحباطات السياسية و الاجتماعية الماضية هي توكيد لرؤيته الفذة ، لحال هذه الدنيا حولنا .
عندما التقيت بهما ، كانا طافحين على آخرهما بالروح ، مترعين ككأس ، بتجارب الماضي .
و بدلا من أن المح خطوطاً حزينة على وجهيهما شأن كل سكان الشرق الأوسط الأكثر إبداعا و إنتاجا ، كانت ابتسامة بريئة عامرة مثل ابتسامة طفل تشرق في وجهيهما . انها ابتسامة الممتن لكرم الله الذي منَ عليهما بنعمة الفن المباركة التي حمتهما و صانتهما من جنون فالت من عقاله يسمى : الدنيا .
بقلم : كلاديس مطر

khawla1- Admin
- عدد المساهمات : 1586
تاريخ التسجيل : 06/01/2009
العمر : 29
 رد: الكون في لوحة
رد: الكون في لوحة
merci

elhamdani_2009- عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 18/05/2009
العمر : 30
الموقع : RISSANI
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى